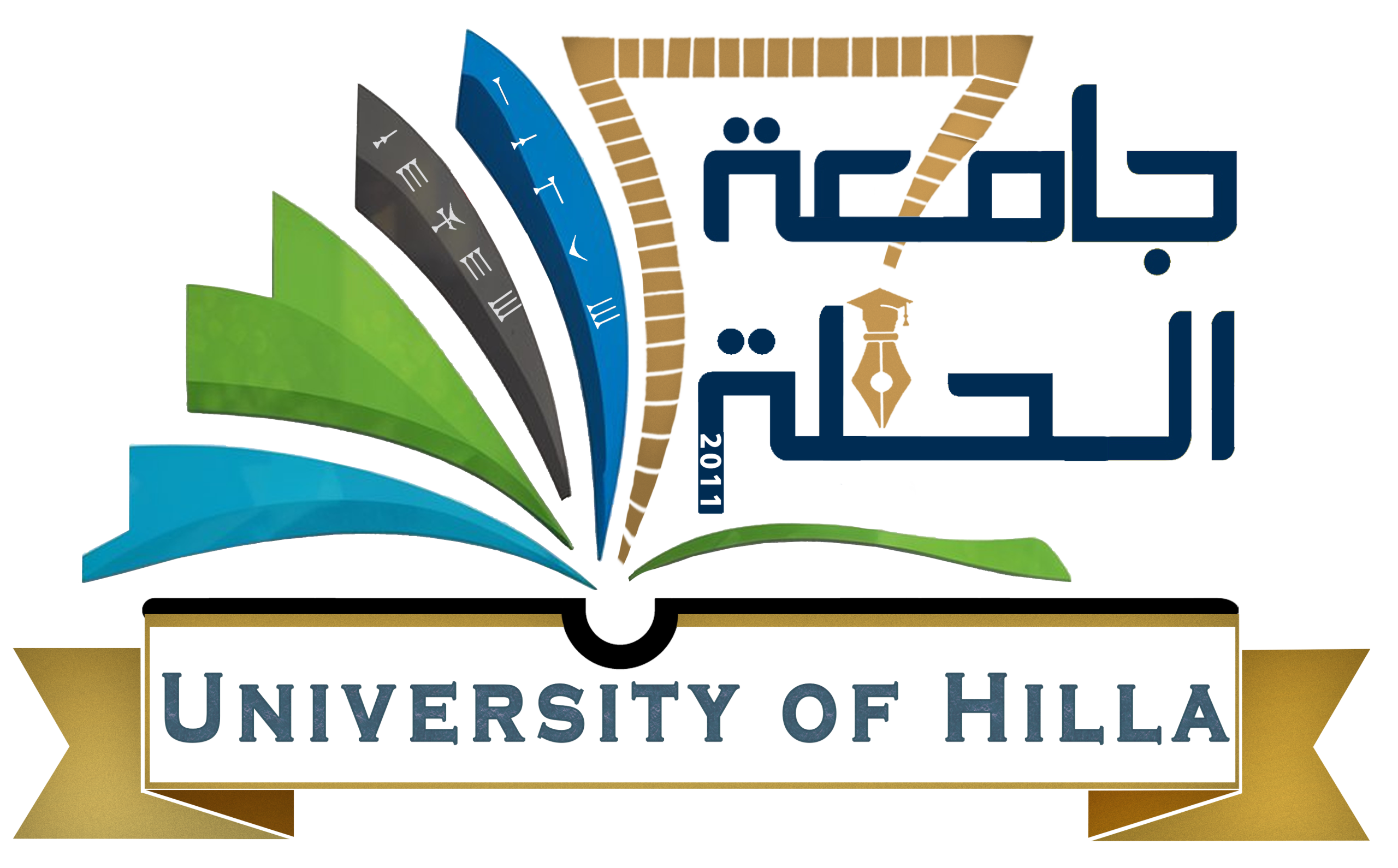- تقرير تحليلي لنتائج استبانة الخطة الاستراتيجية لجامعة الحلة (2024–2028)
- تقرير تحليلي لاستبانة تقييم أداء خريجي جامعة الحلة من قبل أرباب العمل
- تقرير تحليلي لنتائج استبيان رضا الطلبة عن نظام التقويم والقياس
- تقرير تحليلي للتغذية الراجعة من طلبة المرحلة الثالثة – مادة أسس التخدير-قسم التخدير
- تقرير تحليلي شامل لنتائج استبانة قياس رضا المستفيدين من خدمة المجتمع
- تقرير تحليلي لنتائج استبيان الرؤيا والرسالة والاهداف
- تقرير تحليلي لنتائج استبانة الخطة البحثية السنوية 2025–2024
- تقرير تحليلي لنتائج استبيان تقييم جودة التعليم والتعلم
- تقرير تحليلي لنتائج استبيان فاعلية توفير المستلزمات البحثية
- تقرير جودة الخدمات الطلابية
أولاً: المقدمة
في ضوء التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي إقليميًا ودوليًا، ومن منطلق حرص جامعة الحلة على تحقيق التميز الأكاديمي وضمان الجودة المؤسسية، شرعت الجامعة في إعداد خطة استراتيجية متكاملة تمتد للسنوات الخمس (2024–2028). وتهدف هذه الخطة إلى تطوير التعليم الجامعي بما يتواءم مع المتغيرات التكنولوجية، وسوق العمل، والتحديات المجتمعية، فضلًا عن تعزيز مكانة الجامعة بين نظيراتها على المستويين الوطني والدولي.
ولضمان نجاعة هذه الخطة ومصداقيتها، حرصت الجامعة على إشراك أصحاب العلاقة – من تدريسيين وموظفين وطلبة وخريجين وممثلي سوق العمل – عبر إجراء استبانة شاملة تقيس مدى نضج الخطة الاستراتيجية من حيث وضوحها، قابليتها للتطبيق، كفاءة مواردها، وجود مؤشرات أداء مناسبة، وشموليتها لمجالات التطوير المختلفة. وقد جاءت هذه الخطوة تعزيزًا لمبدأ الحوكمة الرشيدة، ومأسسة ثقافة التقييم المستمر، وتفعيل التغذية الراجعة في دعم القرار المؤسسي.
يستعرض هذا التقرير تحليلاً شاملاً لنتائج الاستبانة، مدعومًا بالمؤشرات الكمية والنسب المئوية، متبوعًا بمجموعة من التوصيات العملية، بما يسهم في تعزيز جودة الخطة الاستراتيجية وفاعليتها التنفيذية في ضوء المعايير العالمية المعتمدة في التخطيط الجامعي.
ثانيًا: تحليل النتائج الكمية
| رقم المحور | المؤشر | النسبة | المتوسط الحسابي |
| 1 | وضوح الخطة الاستراتيجية ومفصلتها | 87% | 2.6 |
| 2 | واقعية الأهداف وقابليتها للتحقيق | 84% | 2.5 |
| 3 | مساهمة الخطة في تحسين أداء الجامعة | 83% | 2.5 |
| 4 | كفاية مؤشرات قياس الأداء | 83% | 2.5 |
| 5 | كفاية الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف | 79% | 2.4 |
| 6 | شمولية الخطة وتغطيتها للجوانب المهمة | 77% | 2.3 |
| المعدل العام | 81% | 2.4 |
ثالثًا: التحليل النوعي للمحاور
1- وضوح ومفصلية الخطة الاستراتيجية
يُعد هذا المحور الأعلى تقييمًا، مما يدل على أن الغالبية العظمى من المشاركين(المستفيدين من الجامعة) وجدت أن الخطة مصاغة بوضوح، وتتسم بتسلسل منطقي يربط بين الرسالة والرؤية والأهداف. يشير ذلك إلى أن هناك جهدًا حقيقيًا بُذل في إعداد الخطة من الناحية الشكلية والتنظيمية. ومع ذلك، فإن بعض الردود التي لم تمنح تقييمًا مرتفعًا تستدعي التفكير في تطوير أدوات اتصال داخلية وخارجية توضح مضامين الخطة بلغة مبسطة لجميع أصحاب العلاقة.
2- واقعية الأهداف وقابليتها للتحقيق
تعكس هذه النتائج شعورًا عامًا بإمكانية تنفيذ الأهداف الموضوعة. إلا أن وجود نسبة من المشاركين الذين اتخذوا موقفًا محايدًا أو مترددًا يشير إلى أن بعض الأهداف قد تكون طموحة أو غير مدعومة بخطط تنفيذية واقعية، خصوصًا في ظل تحديات التمويل وتذبذب البيئة التشريعية والتعليمية.
3- مساهمة الخطة في تحسين الأداء المؤسسي
تشير النتائج إلى إدراك غالبية المشاركين لوجود علاقة بين تنفيذ الخطة وتحقيق تحسن في الأداء الأكاديمي والإداري. إلا أن تعزيز هذا الأثر يتطلب مواءمة أفضل بين الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الإنجاز في الكليات والأقسام.
4- كفاية مؤشرات قياس الأداء
يعكس هذا التقييم الحاجة إلى تطوير المؤشرات لتكون أكثر ارتباطًا بالمخرجات الحقيقية، وقابلة للتحليل والمقارنة. ويُوصى بمراجعة هذه المؤشرات بشكل دوري لضمان مرونتها وارتباطها بالأثر لا بالأنشطة فقط.
5- كفاية الموارد المتاحة
الانخفاض الملحوظ هنا يُظهر القلق بشأن محدودية الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة، سواء البشرية أو المالية أو التقنية. وتستوجب هذه الفقرة إجراءات عاجلة لضمان مواءمة الأهداف مع الإمكانيات الفعلية، وربما اعتماد نماذج تمويل بديلة مثل الشراكات والمشاريع الممولة خارجيًا.
6- شمولية الخطة وتغطيتها لكل الجوانب
وهو المحور الأضعف في التقييم، مما يشير إلى وجود فجوات في التغطية الاستراتيجية. وتشمل هذه الفجوات على الأرجح محاور حيوية مثل التحول الرقمي، الاستدامة، دعم ريادة الأعمال، الحوكمة، التدويل، والخدمات الطلابية.
رابعًا: التوصيات
- مراجعة شمولية للخطة وبشكل دوري وعند الحاجة مع تحديث محاور جديدة كالاستدامة، الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، الابتكار ، المسؤولية المجتمعية، والريادة الجامعية.
- تحسين جودة مؤشرات الأداء من خلال تطوير مؤشرات ذكية (SMART) تركز على النتائج، قابلة للقياس الزمني، ومربوطة مباشرة بالأهداف.
- تعزيز التوعية والتواصل من خلال إعداد كتيبات إرشادية، فيديوهات توضيحية، وورش عمل دورية لتعزيز فهم الخطة وآليات تنفيذها.
- مواءمة الخطة مع الموارد المتاحة من خلال إجراء دراسة تقييم فجوات الموارد، وتوجيه الميزانيات وفق الأولويات الاستراتيجية.
- إشراك أصحاب العلاقة في مراجعة الخطة وتنظيم حلقات نقاش مع ممثلي الطلبة، الخريجين، ومؤسسات سوق العمل لجمع الملاحظات المقترحة.
- إعداد تقارير دورية سنوية لرصد التقدم نحو الأهداف، وتحديث الخطط التشغيلية وفقًا للمستجدات.
- إنشاء وحدة تنفيذ استراتيجية تعمل على المتابعة والدعم الفني للكليات والمراكز، وتضمن التكامل بين الخطط التنفيذية.
- عقد ورش مراجعة سنوية من اجل تستعرض المنجزات، التحديات، وتضع تصورًا لتعديل وتحديث الخطة.
- تطوير بوابة إلكترونية تفاعلية او من خلال الموقع الالكتروني للجامعة تُعرض فيها مؤشرات الأداء، ومراحل التقدم، مع فتح المجال للملاحظات والمقترحات.
- الاستفادة من التجارب الدولية عبر شراكات مع جامعات عالمية متميزة لتبادل الخبرات، وتبني ممارسات رائدة.
خامسًا: الخاتمة
تبرز نتائج هذه الاستبانة مؤشرات عامة إيجابية توحي بأن جامعة الحلة تمتلك خطة استراتيجية واضحة المعالم، مدعومة بأهداف منطقية تتماشى مع تطلعات الجامعة. إلا أن نتائج بعض المحاور تشير بوضوح إلى الحاجة لمزيد من التعمق والمراجعة. وفي ضوء ذلك، تصبح المراجعة الدورية والتصحيح المستمر أمرًا بالغ الأهمية لنجاح التنفيذ وتحقيق الأثر المرجو.
تمثل التوصيات المقترحة في هذا التقرير دعائم أساسية لإعادة تشكيل الخطة من الداخل، بما يتناسب مع المتغيرات المستقبلية ويعزز مكانة الجامعة في البيئة التعليمية العراقية والدولية. وتُعد هذه الاستبانة خطوة أولى نحو تأسيس ثقافة تقييم مؤسسي راسخة، تمهّد لتحول استراتيجي عميق في بنية وأداء الجامعة.
أولاً: المقدمة
في إطار سعي جامعة الحلة لتعزيز جودة مخرجاتها التعليمية وربط البرامج الأكاديمية بسوق العمل، تم تنفيذ استبانة شاملة لتقييم أداء الخريجين من وجهة نظر أرباب العمل خلال العام الدراسي 2024–2025. تهدف هذه الاستبانة إلى قياس مدى امتلاك الخريجين للمهارات المهنية والتقنية، وقدرتهم على التكيف مع بيئات العمل المختلفة، بالإضافة إلى تقييم كفاءاتهم في التواصل، التعلم، وحل المشكلات. وتعد آراء أرباب العمل مؤشراً حيوياً لتقييم مدى مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع احتياجات السوق، وتساعد في تحسين البرامج الدراسية، وتطوير المهارات العملية للطلبة، وتحديد الفجوات التدريبية.
تظهر نتائج هذا التقييم أن هناك جوانب من القوة وأخرى تحتاج إلى تحسينات عاجلة، خاصة في المهارات الشخصية ومهارات حل المشكلات. يعكس التقرير التالي مدى استجابة الخطة التعليمية لاحتياجات الواقع المهني، ويوفر توصيات عملية لتعزيز كفاءة الخريجين وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل.
ثانيًا: تحليل النتائج الكمية
| رقم المحور | المؤشر | النسبة | المتوسط الحسابي |
| 1 | يمتلك الخريجون مهارات مهنية وتقنية تؤهلهم للعمل في اختصاصهم | 73% | 4.4 |
| 2 | يتمتع الخريجون بأداء مرضٍ في الشركة/المؤسسة | 76% | 4.5 |
| 3 | يمتلك الخريجون مهارات التواصل والتفاعل في بيئة العمل | 74% | 4.4 |
| 4 | قدرة الخريجين على التعلم واكتساب المهارات بفعالية | 72% | 4.3 |
| 5 | يمتلك الخريجون مهارة حل المشكلات التي يواجهونها في العمل | 64% | 3.9 |
ثالثًا: التحليل النوعي للمحاور
1- امتلاك المهارات المهنية والتقنية
تشير النتائج إلى أن الخريجين يمتلكون أساسًا جيدًا من المهارات المهنية والتقنية المرتبطة بتخصصاتهم، ما يعكس توافقًا مقبولًا بين الجانب النظري والتطبيقي في المناهج الدراسية. ومع ذلك، فإن نسبة التقييم بـ”ممتاز” كانت متواضعة (3 فقط من 39)، مما يبرز وجود فجوة في التدريب العملي الميداني داخل الكليات. ويُحتمل أن يكون السبب في ذلك ضعف البنية التحتية للتدريب أو قلة الشراكات مع المؤسسات التي توفر فرص التطبيق العملي. وهذا يستدعي إعادة النظر في آليات التدريب العملي وتوسيع نطاقه ليشمل حالات واقعية في بيئة العمل.
2- الاداء المرضي للخريجين في سوق العمل
هذا البند حقق أعلى نسبة رضا من أرباب العمل، مما يعكس قدرة خريجي جامعة الحلة على أداء المهام الوظيفية بفاعلية مقبولة. ويشير ذلك إلى وجود كفاءات تخصصية ملحوظة تؤهل الخريج لأداء جيد ضمن بيئة العمل. كما يُعد هذا مؤشراً إيجابياً على كفاءة البرامج الأكاديمية الأساسية في إعداد الخريجين مهنياً. غير أن هذه النتيجة لا تغني عن ضرورة تعميق البعد العملي، بل تدعو إلى تعزيز مهارات القيادة والتفكير التحليلي بما يدعم الأداء المتميز وليس المرضي فقط.
3- امتلاك الخريجون مهارات التواصل والتفاعل
رغم أن النسبة العامة كانت جيدة، إلا أن التقييمات الممتازة ظلت دون المستوى (7 فقط)، ما يُبرز ضعفًا نسبيًا في الجوانب الشخصية لدى الخريجين، وخاصة القدرة على التواصل الفعال، العمل ضمن فريق، وإدارة النزاعات. هذا التحدي يُمكن معالجته عبر تعزيز مقررات تنمية المهارات الناعمة (Soft Skills)، وإدماج الطلبة في نشاطات حياتية واقعية تحاكي بيئة العمل منذ السنوات الأولى في الجامعة.
4- القدرة على التعلم واكتساب المهارات
تشير النتيجة إلى أن الخريجين لديهم استعداد عام للتعلم، لكن تراجع نسبة التقييمات العالية يؤكد أن هناك حاجة لتشجيع التعلم الذاتي والمستمر. يُوصى بإدماج أساليب تدريس حديثة مثل التعلم القائم على المشكلات (PBL)، والتعليم المدمج، وتكليف الطلبة بمشاريع تعتمد على البحث والاستقصاء، مما يسهم في بناء قدراتهم على التكيف مع متغيرات سوق العمل.
5- امتلاك مهارة حل المشكلات التي يواجهونها في العمل
يُعد هذا المحور الأضعف، وهو ما يسلط الضوء على فجوة جوهرية في بناء مهارات التفكير النقدي والتحليلي واتخاذ القرار. غالبًا ما تُدرّس المناهج بطريقة تقليدية لا تعزز روح المبادرة أو الابتكار، مما يؤثر سلبًا على قدرة الخريج على مواجهة التحديات اليومية في بيئة العمل. يتطلب هذا المحور تدخلًا مباشرًا في السياسات الأكاديمية وممارسات التدريس، بما في ذلك التدريب على الحالات الواقعية، والتمارين الجماعية التي تحاكي مشكلات فعلية في بيئة العمل.
رابعًا: التوصيات
- تعزيز برامج المهارات الحياتية ضمن المناهج، خاصة مهارات التواصل، حل المشكلات، والتفكير النقدي.
- إدخال مقررات تدريب عملي ميداني إلزامي في السنوات النهائية، وربطها بمشاكل حقيقية في سوق العمل.
- إنشاء وحدة متابعة الخريجين وسوق العمل لتقييم الأداء المهني بعد التخرج وتحديث الخطط الدراسية بناءً على الملاحظات.
- تنظيم ورش عمل منتظمة لأعضاء هيئة التدريس حول متطلبات سوق العمل وربط مخرجات المقررات بهذه المتطلبات.
- إشراك أرباب العمل في تقييم مشاريع التخرج والمساهمة في تصميم البرامج الأكاديمية المشتركة.
- إقامة برامج تدريبية صيفية إلزامية للطلبة في المؤسسات والشركات لضمان اكتساب المهارات الواقعية.
- إدخال اختبارات الكفاءة المهنية في نهاية الدراسة لقياس مدى تأهل الطلبة للعمل الميداني.
- تشجيع الطلبة على المشاركة في مسابقات الابتكار وريادة الأعمال لتعزيز المهارات التطبيقية.
- اعتماد أسلوب التعليم القائم على حل المشكلات (PBL) في معظم المقررات وخاصة التخصصات التطبيقية.
- توسيع برامج المتابعة بعد التخرج لتشمل تحليلاً سنويًا لأداء الخريجين في بيئات العمل..
خامسًا: الخاتمة
تعكس نتائج استبانة أرباب العمل مستوى مرضياً من أداء خريجي جامعة الحلة، خصوصًا في الجوانب الفنية والتخصصية. ومع ذلك، فإن ضعف مهارات حل المشكلات والتفاعل مع بيئة العمل يؤكد الحاجة إلى تحديث أساليب التدريس وتعزيز الجوانب المهارية. ومن خلال تبني التوصيات المقترحة، يمكن للجامعة أن تضمن تخريج طلبة أكثر جاهزية لسوق العمل وأكثر قدرة على المنافسة محليًا ودوليًا، مما يعزز من سمعتها الأكاديمية ويحقق أهداف التنمية المستدامة في التعليم.
أولاً: المقدمة
يمثل نظام التقويم والقياس في الجامعات ركيزة أساسية لضمان جودة العملية التعليمية، فهو الأداة التي تُستخدم لقياس مدى تحقق مخرجات التعلم وتقييم أداء الطلبة بعد خضوعهم للتعليم النظري والعملي.
ولا يقتصر دوره على قياس التحصيل الدراسي، بل يمتد ليشمل العدالة والشفافية في التقييم، وتقديم تغذية راجعة تساعد الطلبة على تحسين مستوياتهم الأكاديمية.
وانطلاقًا من حرص جامعة الحلة على تعزيز جودة التعليم وضمان رضا طلبتها، نفذت الجامعة استبيانًا شاملاً لقياس مدى رضا الطلبة عن نظام التقويم والقياس الحالي (الامتحانات) للعام الدراسي 2023–2024.
يهدف هذا الاستبيان إلى الوقوف على نقاط القوة والضعف في النظام الحالي من خلال ستة محاور رئيسية:
مدى الرضا العام عن النظام، وضوح المعايير وشفافيتها، تلبية احتياجات الطلبة الفردية، عدالة التقييمات، فعالية التغذية الراجعة المقدمة من الأساتذة، ومدى دقة النظام في عكس المستوى الأكاديمي للطلبة.
وتأتي هذه الدراسة التحليلية كخطوة أساسية لتطوير آليات التقييم بما يتوافق مع المعايير العالمية في التعليم العالي، ويساعد على بناء منظومة تقويم أكثر إنصافًا وفاعلية واستجابة للتحديات الأكاديمية والمهنية.
ثانيًا: تحليل النتائج الكمية
| رقم المحور | المؤشر | النسبة | المتوسط الحسابي |
| 1 | مدى رضاك عن نظام التقويم الحالي | 63% | 3.8 |
| 2 | وضوح وشفافية المعايير المستخدمة في التقييم | 72% | 4.3 |
| 3 | مدى تلبية نظام التقويم الحالي لاحتياجاتك الفردية في التعلم | 66% | 4.0 |
| 4 | عدالة التقييمات والامتحانات في النظام الحالي | 64% | 3.9 |
| 5 | تلقيك لتغذية راجعة فعالة من الأساتذة بعد التقييمات | 65% | 3.9 |
| 6 | مدى قدرة نظام التقويم الحالي على عكس مستواك الأكاديمي بدقة | 60% | 3.6 |
| المعدل العام | 66% | 4.0 | |
ثالثًا: التحليل النوعي للمحاور
1- الرضا العام عن نظام التقويم (63% – 3.8):
يعكس مستوى رضا متوسط، ما يشير إلى وجود فجوة بين توقعات الطلبة وبين ما يقدمه النظام الحالي، خاصة فيما يتعلق بآليات تطبيق الامتحانات وتنوعها.
2- وضوح وشفافية المعايير (72% – 4.3):
حصل هذا المحور على أعلى تقييم، مما يعكس إدراك الطلبة لوجود معايير واضحة إلى حد كبير. غير أن نسبة من الطلبة طالبت بمزيد من الشفافية في تفسير الدرجات وآلية التصحيح.
3- مدى تلبية النظام لاحتياجات الطلبة الفردية (66% – 4.0):
يشير إلى أن النظام يستجيب جزئيًا لاحتياجات الطلبة، لكنه لا يراعي الفروق الفردية بشكل كافٍ. يُوصى بتفعيل أدوات تقييم متنوعة مثل الاختبارات الشفهية والمشاريع التطبيقية.
4-عدالة التقييمات والامتحانات (64% – 3.9):
تعكس هذه النتيجة وجود مخاوف لدى الطلبة بشأن العدالة، سواء في تنوع الأسئلة أو في أسلوب التصحيح. وهذا يتطلب مراقبة أكثر صرامة لضمان النزاهة والحيادية.
5- فعالية التغذية الراجعة (65% – 3.9):
تُظهر النتيجة أن الطلبة يتلقون تغذية راجعة، لكنها غير كافية أو غير منتظمة. تمثل هذه الفجوة تحديًا كبيرًا في تحسين تعلم الطلبة وتطوير أدائهم المستقبلي.
6- قدرة النظام على عكس المستوى الأكاديمي بدقة (60% – 3.6):
النسبة الأدنى بين المحاور، مما يشير إلى أن النظام لا يعكس بدقة المستوى الحقيقي لبعض الطلبة. ويبرز هنا ضرورة تنويع أدوات القياس لتشمل الاختبارات العملية، والمقابلات، والتقييم المستمر.
رابعًا: التوصيات
- تطوير نظام تقييم متنوع يشمل الامتحانات، المشاريع، التقييم العملي، والاختبارات المستمرة.
- زيادة شفافية التصحيح من خلال نشر نماذج إجابة توضيحية أو عقد جلسات مراجعة مع الطلبة.
- تعزيز العدالة في صياغة الأسئلة وتوزيع الدرجات، وضمان اتساقها مع مخرجات التعلم.
- إدماج التغذية الراجعة الفعالة كجزء أساسي من عملية التقويم، وتخصيص وقت لمناقشة الأداء مع الطلبة.
- مراعاة الفروق الفردية عبر أساليب تقييم مرنة تراعي أنماط التعلم المختلفة.
- اعتماد أنظمة الكترونية حديثة للتقويم تتيح دقة أعلى في التصحيح والتحليل، وتقلل من التحيز البشري.
- تدريب أعضاء هيئة التدريس على أحدث أساليب القياس والتقويم التربوي.
- إجراء مراجعة دورية للنظام وفقًا لمعايير الجودة الوطنية والدولية في التعليم العالي.
خامسًا: الخاتمة
تشير نتائج استبيان رضا الطلبة عن نظام التقويم والقياس في جامعة الحلة إلى وجود مستوى متوسط من الرضا العام، مع إبراز محاور قوة تتمثل في وضوح المعايير وشفافيتها، مقابل محاور ضعف بارزة في دقة النظام وعدالته وفاعلية التغذية الراجعة. ويؤكد ذلك الحاجة الماسة إلى مراجعة شاملة للنظام الحالي وتبني آليات تقييم أكثر شمولًا وإنصافًا.
إن تطوير نظام التقويم ليكون أكثر عدالة وشفافية ومرونة يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة التعليم ومخرجاته. ويُعد إشراك الطلبة في عملية التطوير عبر التغذية الراجعة المستمرة أداة فعّالة لتجويد الممارسات الأكاديمية وضمان بناء نظام تقييم يعكس الكفاءة الحقيقية للطلبة، ويساعد الجامعة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في الجودة والتميز الأكاديمي.
أولاً: المقدمة
في إطار تطبيق نظام ضمان الجودة والتحسين المستمر في العملية التعليمية، وحرصًا من قسم التخدير في جامعة الحلة على متابعة جودة التدريس ومدى رضا الطلبة عن الخدمات التعليمية المقدمة، تم إجراء استبيان للتغذية الراجعة من طلبة المرحلة الثالثة بشأن تدريس مادة أسس التخدير للعام الدراسي 2024–2025.
يهدف هذا التقييم إلى رصد مستوى استيعاب الطلبة للمادة العلمية، ومدى فاعلية أساليب التدريس المستخدمة، وتقييم مشاركة الطلبة، والتفاعل داخل الصف، وتنويع الوسائل التعليمية. ويُعد هذا التحليل أداة مهمة تساعد في تحسين جودة التدريس وتطوير أداء التدريسيين.
ثانيًا: التحليل الكمي لنتائج الاستبيان
- مدى استيعاب المادة العلمية:
- أكثر من 75% 34.2:%
- من 50–75% 31.5:%
- أقل من 50% 24.7:%
- تدل هذه النتائج على أن حوالي 65% من الطلبة أظهروا استيعابًا متوسطًا إلى عالٍ، بينما بقي ربع الطلبة دون المستوى المقبول، وهو ما يشير إلى تفاوت واضح يحتاج للمعالجة.
- استخدام طرق حديثة في تقديم المادة:
- نعم 38.4%:
- إلى حد ما: 26%
- كلا 35.6%:
- تظهر النتائج أن حوالي 62% من الطلبة لا يشعرون باستخدام منهجي لطرق التدريس الحديثة، ما يستدعي التوسع في استخدام التقنيات التفاعلية والعرض الرقمي والنماذج العملية.
- تنوع أساليب شرح المادة العلمية:
- نعم 34.2%:
- إلى حد ما 39.7%:
- كلا 26%:
- غالبية الطلبة يرون أن هناك تنوعًا جزئيًا فقط، مما يشير إلى وجود إمكانية حقيقية لتطوير أساليب الشرح بحيث تراعي الفروقات الفردية بين الطلبة.
- تناول الحضور والغياب وتفعيل الأنشطة الصفية:
- نعم 79.5%:
- إلى حد ما 13.7%:
- كلا 6.8%:
- هذا المحور يُعد الأعلى رضاً، ويدل على اهتمام تدريسي المادة بانضباط الصف وتفعيل التفاعل داخل المحاضرة، وهو مؤشر إيجابي يعزز جودة التعلم.
- الاعتماد على الكوزات (الاختبارات القصيرة) داخل المحاضرة:
- نعم 32.9%:
- إلى حد ما 50.7%:
- كلا 16.4%:
- اعتماد الكوزات لم يُفعل بالشكل المطلوب رغم فوائده الكبيرة في تعزيز الفهم، مما يستوجب وضع خطة واضحة لتفعيله دورياً ضمن المنهج.
ثالثًا: تحليل نوعي وتعليقات الطلبة
- الكثير من الطلبة أشادوا بقسم من التدريسين واسلوبهم، ووُصف الشرح بأنه “راقي”، و”واضح”، و”يناسب فكر الطالب”.
- أبدى عدد من الطلبة رغبة في زيادة استخدام الأمثلة السريرية العملية، وربط المعلومات النظرية بالحالات الواقعية.
- بعض الطلبة أشاروا إلى التكرار في الطرح وعدم كفاية الوقت في بعض المحاضرات، واقترحوا تنويع مصادر المادة.
- طُرحت حاجة لإضافة نشاطات تطبيقية أكثر واختبارات دورية قصيرة لتعزيز المعلومة.
رابعًا: التوصيات
- تطوير أساليب التدريس عبر استخدام العروض التفاعلية، المحاكاة، الفيديوهات الطبية، وتطبيقات الهاتف الذكية.
- إدخال اختبارات قصيرة منتظمة (كوزات) لقياس استيعاب الطلبة وتعزيز التغذية الراجعة الفورية.
- تنويع أساليب الشرح لتشمل الأسلوب القصصي، ربط المادة بالواقع، والتعلم القائم على حل المشكلات (PBL)
- إشراك الطلبة في تقييم المقرر أثناء الفصل لضبط الإيقاع التعليمي مبكرًا.
- زيادة الأمثلة السريرية وربطها ببيئة العمل الحقيقي لتقوية الجوانب التطبيقية.
- مواصلة تفعيل الحضور والأنشطة مع تطوير أدوات المشاركة الصفية.
- تنظيم لقاء حواري نصف فصلي بين التدريسي والطلبة لمراجعة تقدم المادة ومقترحات التحسين.
خامسًا: الخاتمة
تكشف نتائج التغذية الراجعة لمادة أسس التخدير عن أداء تدريسي جيد وتفاعل طلابي إيجابي في عدة جوانب، لاسيما في ما يخص الحضور والأنشطة الصفية، إلا أن النتائج تشير أيضًا إلى فرص تطوير كبيرة في أساليب التدريس وتنويع طرق الشرح وتفعيل أدوات التقويم المستمر.
يُعد هذا التقييم فرصة مهمة لقسم التخدير لتحديث استراتيجيات التدريس في المواد السريرية وتعزيز ثقافة الجودة والتقييم المستمر، بما يُسهم في رفع كفاءة طلبة القسم وتأهيلهم ميدانيًا ومهنيًا بما يواكب متطلبات سوق العمل الطبي الحديث.
أولاً: المقدمة
تحرص جامعة الحلة على أداء دور محوري في خدمة المجتمع المحلي، انطلاقًا من رؤيتها في أن تكون مؤسسة تعليمية رائدة ليس فقط في المجال الأكاديمي بل في التنمية المجتمعية المستدامة أيضًا. ويعد هذا الدور امتدادًا لرسالتها في بناء شراكات مجتمعية مؤثرة، وتقديم مبادرات تنموية هادفة تسهم في النهوض بواقع المجتمع بمختلف فئاته وقطاعاته.
ومن هذا المنطلق، أطلقت الجامعة استبانة لقياس رضا المستفيدين من خدمة المجتمع خلال العام الأكاديمي 2024–2025، بهدف تشخيص مستوى الفاعلية والاستجابة، وتحديد مدى توافق الخدمات الجامعية مع احتياجات المجتمع، ومدى إسهامها في حل مشكلاته وتعزيز التنمية المستدامة.
تشكل نتائج هذه الاستبانة أداة تقويمية استراتيجية تساعد الجامعة على تحسين جودة برامجها المجتمعية وتوسيع نطاق تأثيرها. وقد شملت الاستبانة عينة متنوعة من القطاعات (الحكومي، الخاص، المشترك)، ومن الفئات (طلبة، تدريسيون، إداريون، ممثلو المجتمع المدني)، ما يُعزز مصداقية النتائج ويجعل التحليل أكثر شمولاً ودقة.
يستعرض هذا التقرير تحليلاً شاملاً لنتائج الاستبانة، مدعومًا بالمؤشرات الكمية والنسب المئوية، متبوعًا بمجموعة من التوصيات العملية، بما يسهم في تعزيز جودة الخطة الاستراتيجية وفاعليتها التنفيذية في ضوء المعايير العالمية المعتمدة في التخطيط الجامعي.
ثانيًا: تحليل النتائج الكمية
1- توزيع المشاركين حسب نوع المؤسسة:
- قطاع حكومي: 53.3%
- قطاع خاص: 46.7%
2- توزيع المشاركين حسب الصفة:
- إدارة جامعية: 13.3%
- إدارة جامعية + عضو هيئة تدريس: 20%
- عضو هيئة تدريس: 33.3%
- طلبة: 26.7%
- أعضاء مجتمع مدني: غير مصرح
- أخرى: غير مصرح
- تقييم المحاور الرئيسة للاستبانة:
| رقم المحور | المؤشر | النسبة |
| 1 | استراتيجية الجامعة في خدمة المجتمع فعالة وشاملة | 33.3% |
| 2 | تقدم الجامعة خدمات متميزة للمجتمع | 40% |
| 3 | تقدم الجامعة الدعم والمساعدة المناسبة للمجتمع المحلي | 46.7% |
| 4 | تلبي الجامعة احتياجات المجتمع المتنوعة بشكل فعال | 33.3% |
| 5 | تعمل الجامعة على حل المشكلات وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع المحلي | 40% |
ثالثا: التحليل النوعي للمحاور
- فعالية استراتيجية الجامعة في خدمة المجتمع
رغم أن 33.3% من المشاركين وافقوا على أن استراتيجية الجامعة في خدمة المجتمع فعالة، إلا أن نسبة المحايدين (66.7%) تعكس وجود غموض أو عدم اطلاع كافٍ على مكونات الاستراتيجية وأهدافها التنفيذية. هذا يشير إلى ضرورة تعزيز التوعية الإعلامية والاستراتيجية التشاركية.
جودة الخدمات المقدمة للمجتمع
بلغت نسبة الرضا عن الخدمات 40%، في حين أبدى أكثر من نصف المشاركين موقفًا محايدًا. هذه النتيجة تُبرز الحاجة إلى تحسين نوعية الخدمات، وضمان استمراريتها، وتقييم أثرها الفعلي على الفئات المستفيدة.
- الدعم والمساعدة المقدمة للمجتمع المحلي
أعلى نسبة رضا (46.7%) كانت في هذا المحور، ما يعكس تقديرًا واضحًا من المستفيدين للدعم الذي توفره الجامعة. ومع ذلك، يبقى غياب التقييم بـ “غير موافق” مؤشرًا إيجابيًا يتطلب تعزيز الجوانب الناجحة وتعميقها.
- تلبي احتياجات المجتمع المتنوعة
نسبة الرضا العامة (33.3%) تشير إلى أن هناك جهودًا تبذل، لكنها غير كافية أو غير موجهة بدقة نحو احتياجات المجتمع الحقيقية، مما يستوجب تفعيل آليات التشخيص الدقيق للاحتياجات المجتمعية وتخصيص برامج موجهة.
- المساهمة في حل المشكلات وتعزيز التنمية
كانت هذه الفقرة الأكثر تباينًا، حيث بلغت نسبة “غير موافق” 20%، وهي الأعلى في الاستبانة، ما يدل على ضعف إدراك المجتمع لدور الجامعة في تقديم حلول فعلية ومستدامة للمشاكل المجتمعية. يتطلب ذلك تطوير مشاريع بحثية ومبادرات ميدانية تُسهم بوضوح في التنمية المستدامة.
رابعًا: التوصيات
- تطوير استراتيجية شاملة ومعلنة لخدمة المجتمع تكون مرئية ومفهومة لجميع أصحاب العلاقة، ومبنية على تحليل علمي لاحتياجات البيئة المحلية.
- تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي من خلال الندوات، الورش، المعارض، والمبادرات التطوعية التي تُبرز دور الجامعة كمصدر للمعرفة والتنمية.
- إشراك المستفيدين في تصميم وتنفيذ البرامج المجتمعية لضمان توافقها مع توقعاتهم واحتياجاتهم الفعلية.
- قياس الأثر الفعلي لبرامج خدمة المجتمع من خلال مؤشرات أداء دورية تشمل جودة الحياة، الرضا، والتنمية.
- تحفيز الباحثين والأساتذة على تنفيذ مشاريع مجتمعية تطبيقية مدعومة من الجامعة أو من جهات داعمة خارجية.
- تفعيل وحدة متابعة وتقييم رضا المستفيدين لتقديم تغذية راجعة مستمرة تصب في تحسين الأداء.
- إعداد تقارير دورية شفافة تنشر على موقع الجامعة حول الأنشطة المجتمعية وتأثيرها ومؤشرات الأداء المرتبطة بها.
- ربط العمل المجتمعي بالبرامج الدراسية وتشجيع الطلبة على إنجاز مشاريع تخرج ومبادرات تطبيقية تخدم المجتمع.
- عقد شراكات استراتيجية مع منظمات المجتمع المدني لتوسيع نطاق التأثير وتبادل الخبرات.
- إدخال مفهوم المواطنة والريادة المجتمعية في المناهج الدراسية لتأصيل ثقافة الخدمة المجتمعية لدى الطلبة.
خامسًا: الخاتمة
تكشف نتائج استبانة رضا المستفيدين من خدمات جامعة الحلة المجتمعية للعام الأكاديمي 2023–2024 عن وجود قاعدة إيجابية قابلة للتطوير، تعكس التزامًا أوليًا من الجامعة بدورها في خدمة المجتمع. فقد أظهرت المؤشرات مستويات مقبولة من الرضا في بعض المحاور، مما يدل على وجود مبادرات فاعلة وبرامج ذات أثر، لكنها ما تزال بحاجة إلى مزيد من التنظيم، والتخطيط المؤسسي، والتفاعل المنهجي مع حاجات المجتمع المحلي.
ومع ذلك، فإن بروز جوانب الضعف في بعض المؤشرات – لاسيما ما يتعلق بغموض الاستراتيجية، وانخفاض نسبة الرضا المرتفع، وتكرار الإجابات المحايدة – يُعد بمثابة مؤشر إنذاري يدعو إلى وقفة جادة لتقويم الأداء، وإعادة بناء منظومة خدمة المجتمع على أسس أكثر فاعلية وشراكة واستدامة.
ويشكل هذا التقرير، بكل ما تضمنه من تحليل وتوصيات، فرصة استراتيجية مهمة لإعادة هيكلة نهج الجامعة تجاه خدمة المجتمع، عبر الانتقال من المبادرات الفردية إلى منظومة مؤسسية مترابطة، تستند إلى رؤية واضحة، وأهداف قابلة للقياس، وشراكات فاعلة مع الجهات المجتمعية والمؤسساتية.
إن تفعيل التوصيات المطروحة سيمكن الجامعة من تعزيز موقعها كمؤسسة تعليمية وتنموية قائدة، تلعب دورًا محوريًا في تشخيص المشكلات المجتمعية وإيجاد حلول علمية مستدامة لها. كما سيسهم في تحويل الجامعة إلى حلقة وصل ديناميكية بين المعرفة الأكاديمية واحتياجات الواقع المحلي، بما يرسّخ موقعها في قلب عملية التنمية الوطنية، ويجعلها نموذجًا يحتذى به في بناء الجامعات ذات الأثر المجتمعي.
وفي ضوء هذه الرؤية، فإن جامعة الحلة مدعوة اليوم إلى استثمار هذا التقييم كأداة تطوير فعالة، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التكامل بين رسالتها الأكاديمية ودورها المجتمعي، بما يعزز ثقة المجتمع بها ويزيد من فاعلية دورها في تحقيق أهداف رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030.
أولاً: المقدمة
في إطار سعي جامعة الحلة لترسيخ هويتها المؤسسية وتوجيه برامجها الأكاديمية والإدارية ضمن إطار استراتيجي متماسك، أُجري هذا الاستبيان لتقييم مدى وضوح وفعالية رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها. تُعد هذه المكونات الأساس الفكري والإداري الذي تستند إليه خطط التطوير في التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع.
ويهدف هذا التقييم إلى قياس مستوى وعي منتسبي الجامعة (طلبة، تدريسيين، إداريين) بمضامين الرؤية والرسالة، ومدى انسجامها مع القيم المجتمعية وسوق العمل، بالإضافة إلى معرفة مدى شعورهم بملاءمتها للواقع الأكاديمي والتطبيقي للجامعة. وتُعد هذه البيانات مصدرًا أساسيًا للتغذية الراجعة في عملية التخطيط الاستراتيجي الممتد إلى عام 2028.
ثانيًا: تحليل النتائج الكمية
| رقم المحور | المؤشر | النسبة | المتوسط الحسابي |
| 1 | وضوح رؤية ورسالة الجامعة | 83% | 2.5 |
| 2 | تعكس رؤية ورسالة الجامعة أهدافها ومبادئها والقيم المجتمعية | 84% | 2.5 |
| 3 | رؤية ورسالة الجامعة مرضية بشكل عام | 78% | 2.3 |
| 4 | تتوافق الجامعة مع قيمها ومبادئها في تطبيقها العملي | 84% | 2.5 |
| 5 | تتوافق رؤية ورسالة الجامعة مع احتياجات سوق العمل | 84% | 2.5 |
| المتوسط العام | 82% | 2.5 | |
ثالثًا: التحليل النوعي للمحاور
- وضوح رؤية ورسالة الجامعة
تُظهر نسبة 83% ومتوسط 2.5 درجة قبول عالية بين المشاركين، مما يدل على أن الرؤية والرسالة مفهومتان ومتاحتان لدى المنتسبين، مع وجود بعض الحاجة إلى تعزيز الوعي بها عبر الوسائل الرقمية والمطبوعات الرسمية .
- ارتباط الرسالة بالقيم المجتمعية
النسبة الأعلى في النتائج (84%) تعكس تقاربًا ملحوظًا بين مكونات الرسالة وأهداف التنمية المحلية. هذا يُشير إلى أن رؤية الجامعة ليست منعزلة عن السياق الوطني والمجتمعي.
- مدى الرضا العام عن الرؤية والرسالة
حصل هذا المحور على النسبة الأدنى (78%)، ما يشير إلى أن بعض المنتسبين لديهم تحفظات أو يتوقعون صياغة أكثر وضوحًا أو طموحًا. يُوصى بمراجعة صياغة الرسالة بلغة أكثر تحفيزًا وشمولية.
- تطبيق القيم والمبادئ على أرض الواقع
النسبة (84%) تعكس ثقة نسبية بأن القيم المعلنة لا تبقى حبرًا على ورق، بل تجد طريقها إلى التطبيق، مما يُعزز مصداقية المؤسسة.
- ارتباط الرؤية بسوق العمل
تمثل النتيجة المرتفعة (84%) دلالة قوية على شعور المنتسبين بأن الجامعة تأخذ متطلبات السوق بعين الاعتبار، ما يعكس توافقًا جيدًا مع التوجهات الحديثة في التعليم المرتبط بالتوظيف والريادة.
رابعًا: التوصيات
- إعادة نشر الرؤية والرسالة وتعزيز وضوحها من خلال اللوحات الإرشادية والمنصات الرقمية.
- مراجعة وصياغة الرؤية بلغة أكثر طموحًا ومُلهمة، تربط الماضي بالحاضر والمستقبل.
- إدماج مكونات الرؤية والرسالة في البرامج التوجيهية للطلبة الجدد وأعضاء الهيئة التدريسية.
- إجراء استبيانات مماثلة دورية لتتبع مدى فهم وتطبيق هذه المكونات في الواقع الجامعي.
- مواءمة الخطط الدراسية والأنشطة الطلابية مع مضامين الرؤية والرسالة لتفعيلها عمليًا.
- إشراك المجتمع المحلي وسوق العمل في إعادة صياغة أو تحديث الرسالة بشكل دوري.
خامسًا: الخاتمة
تعكس نتائج استبيان تقييم رؤية ورسالة وأهداف جامعة الحلة لعام 2023–2024 صورة إيجابية عامة، تتسم بمستويات عالية من الوعي والرضا بين المستجيبين. ويُعد هذا التقييم جزءًا أساسيًا من أدوات الحوكمة والشفافية داخل الجامعة، ويساهم في تعزيز ثقافة المساءلة والتطوير المؤسسي المستمر.
ومع أن النتائج تُشير إلى وجود تقبل وتوافق مع محتوى الرؤية والرسالة، إلا أن التحدي القادم يتمثل في تفعيل هذه القيم على مستوى البرامج والخطط الأكاديمية والتربوية، وربطها بمؤشرات أداء قابلة للقياس. كما أن إشراك أصحاب المصلحة – داخليًا وخارجيًا – في تطوير هذه الوثائق المرجعية، سيساهم في رفع مستوى الالتزام بها، وتحقيق أهداف الجامعة في الريادة الأكاديمية والمجتمعية، بما يتوافق مع رؤية العراق 2030 للتنمية المستدامة.
أولاً: المقدمة
تُعد الخطط البحثية ركيزة أساسية في تطوير الجامعات والارتقاء بمكانتها الأكاديمية، كونها تحدد أولويات البحث والتطوير، وتعزز الإنتاج العلمي وتستجيب لحاجات المجتمع وسوق العمل. وفي هذا السياق، قامت جامعة الحلة بإعداد خطة بحثية سنوية للعام (2024–2025) تهدف إلى دعم الباحثين وتحفيز الابتكار وتوجيه الجهود البحثية نحو قضايا ذات أولوية محلية وعالمية. ولضمان جودة تنفيذ هذه الخطة ومدى توافقها مع تطلعات المجتمع الأكاديمي، أُجريت استبانة لتقييم فاعليتها من وجهة نظر المنتسبين. وقد تناولت الاستبانة عدة جوانب مهمة: تلبية الخطة لحاجات الباحثين، دعمها للأنشطة البحثية، توفير البنى التحتية، تحفيز الإبداع، ومدى استجابتها لسوق العمل.
يعكس هذا التقييم التزام الجامعة بمبدأ التقييم المستمر وتحسين الأداء، ويسهم في تعزيز بيئة بحثية محفزة للتميز والابتكار. النتائج المستخلصة من هذه الاستبانة توفر مؤشرات دقيقة لتقييم الأداء، وتسهم في تعديل مسار الخطة بما يتماشى مع التغيرات المستجدة. ويشكل هذا التحليل أداة لدعم اتخاذ القرار في مجالات التمويل البحثي وتحديد الأولويات وتوجيه السياسات المستقبلية. ومن خلال قراءة النتائج، يمكن الوقوف على مجالات القوة والتحديات المقترنة بالخطة الحالية.
ثانيًا: تحليل النتائج الكمية
| رقم المحور | المؤشر | النسبة | المتوسط الحسابي |
| 1 | تُلبي الخطة السنوية احتياجاتك البحثية | 81% | 4.8 |
| 2 | تدعم الخطة المشاركة في الأنشطة والفعاليات البحثية داخل وخارج الجامعة | 81% | 4.9 |
| 3 | توفر الخطة بنى تحتية وتجهيزات وموارد كافية لدعم البحث العلمي في الجامعة | 76% | 4.5 |
| 4 | تدعم الخطة البحثية الريادة والابتكار والتميز في البحث العلمي | 79% | 4.8 |
| 5 | تعمل الخطة البحثية على تلبية متطلبات سوق العمل والاستدامة | 79% | 4.8 |
ثالثًا: التحليل التفصيلي لنتائج الاستبانة
- تلبية الخطة السنوية لاحتياجات الباحثين ( 81% – متوسط 4.8)
تشير النتائج إلى رضا واسعمن الباحثين والمستفيدين والطلاب بأن الخطة البحثية تستجيب لاحتياجات الباحثين والمستفيدين، مما يعكس مراعاة التخصصات وتنوع الاهتمامات البحثية. لكن النسبة لم تبلغ مستوى الامتياز (90%+)، ما يشير إلى ضرورة تطوير أدوات تشاركية أوسع أثناء إعداد الخطة.
- دعم الخطة للمشاركة في الأنشطة البحثية داخل وخارج الجامعة (81% – متوسط 4.9 (
حصل هذا البند على أعلى متوسط، مما يدل على أن الخطة البحثية توفر دعماً معقولًا للتعاون البحثي والتواصل العلمي. وقد يكون وراء ذلك تخصيص تمويلات أو برامج للتشبيك مع مؤسسات خارجية.
- توفير البنى التحتية والمعدات لدعم البحث العلمي (76% -متوسط 4.5)
النسبة الأقل بين البنود، ما يعكس وجود تحديات ملموسة في تجهيز المختبرات، توفير قواعد بيانات علمية، أو صيانة الأجهزة. يجب اعتبار هذا المحور أولوية في الخطط البحثية للسنوات القادمة.
- دعم الإبداع والابتكار والتميز في البحث(79% – متوسط 4.8)
يؤكد هذا التقييم أن الخطة البحثية تضع الابتكار ضمن أولوياتها، لكن لا تزال هناك حاجة لتوسيع البرامج الداعمة مثل الجوائز التحفيزية بشكل اكبر، وبرامج احتضان الأفكار البحثية الرائدة.
- مواءمة الخطة لمتطلبات سوق العمل والاستدامة (79% – متوسط 4.8)
تدل النتائج على أن الخطة البحثية لجامعة الحلة تتجه نحو تطبيقية البحث العلمي وربط مخرجاته بالاحتياجات المجتمعية. رغم ذلك، فإن ضعف تفعيل نتائج البحوث في الواقع العملي قد يكون أحد العوائق.
رابعًا: التوصيات
- زيادة الاستثمار في البنى التحتية البحثية من خلال تخصيص موازنات مستقلة لتطوير المختبرات، واشتراك قواعد البيانات، وتحديث الأجهزة.
- إشراك الباحثين الفعليين في إعداد الخطة لضمان تلبية الأولويات الواقعية للتخصصات المختلفة.
- تعزيز دعم المؤتمرات الدولية والنشر العلمي من خلال برامج تحفيزية وتمويل المشاركة.
- إطلاق حاضنات بحثية وتكنولوجية ترتبط بالصناعة والمجتمع المحلي لتسويق نتائج البحوث وتحقيق الاستدامة.
- إعداد خارطة بحثية وطنية تعتمد على تحليل احتياجات السوق، وربط المشاريع البحثية بالأهداف التنموية.
- تصميم برامج لاحتضان الأفكار البحثية المبتكرة، وربطها بمصادر تمويل من القطاعين العام والخاص.
- تفعيل منصات إلكترونية لمتابعة تنفيذ الخطة وتوثيق الإنتاج البحثي ونشر نتائجه بشفافية.
- إجراء تقييم نصف سنوي للبحوث المدعومة وقياس مدى تأثيرها على المستوى العلمي والاقتصادي والاجتماعي.
- تعزيز التدريب على المهارات البحثية وخاصة في تحليل البيانات، النشر الدولي، وبراءات الاختراع.
- تشجيع البحوث متعددة التخصصات وربطها بقضايا بيئية وصحية واجتماعية معاصرة.
خامسًا: الخاتمة
يُظهر تحليل نتائج استبانة الخطة البحثية لجامعة الحلة أن الغالبية العظمى من المستجيبين راضون عن الاتجاهات العامة للخطة، وخصوصًا في دعم الباحثين وتوسيع المشاركة البحثية. ومع ذلك، فإن تراجع التقييم في بند البنى التحتية يستوجب معالجة فورية لتوفير بيئة بحثية متكاملة. إن تعزيز الابتكار والاستجابة لمتطلبات سوق العمل يمثلان ركيزتين أساسيتين يجب البناء عليهما في السنوات القادمة. ومن خلال الأخذ بالتوصيات الواردة، يمكن الارتقاء بالخطة البحثية إلى مستوى الريادة والمنافسة الإقليمية والدولية.
أولاً: المقدمة
في إطار توجه جامعة الحلة لترسيخ معايير الجودة والتميز في التعليم العالي، وتحقيق بيئة تعليمية محفزة وفعّالة، بادرت الجامعة إلى إجراء استبيان شامل لتقييم جودة التعليم والتعلم من وجهة نظر الطلبة. يمثل هذا الاستبيان أداة أساسية لقياس مدى كفاءة البرامج الأكاديمية، وفاعلية الوسائل التعليمية، وجودة التفاعل بين الأستاذ والطالب، إضافةً إلى مدى قدرة الجامعة على تلبية احتياجات الطلبة الأكاديمية والتقنية والإدارية والبيئية.
لقد صُمم الاستبيان ليغطي أربعة محاور رئيسية هي: جودة التعليم والتعلم، أساليب ووسائل التعليم، التعليم الإلكتروني والتعلم المدمج، وتلبية احتياجات الطلبة. ويهدف هذا التقييم إلى تشخيص واقع التعليم والتعلم في الجامعة، وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين، بما يعزز ثقافة التطوير المستمر ويرفع من مستوى رضا الطلبة عن مخرجات التعليم.
ثانيًا: تحليل النتائج الكمية
| رقم المحور | المؤشر | النسبة | المتوسط الحسابي |
| 1 | جودة التعليم والتعلم | 66% | 3.9 |
| 2 | أساليب ووسائل التعليم | 66% | 3.9 |
| 3 | التعليم الإلكتروني والتعلم المدمج | 63% | 3.8 |
| 4 | تلبية احتياجات الطلبة | 63% | 3.8 |
| المعدل العام | 65% | 3.9 | |
ثالثًا: التحليل النوعي للمحاور
1- جودة التعليم والتعلم (66% – 3.9)
- أوضحت النتائج أن الأهداف التعليمية واضحة ومحددة بدرجة مقبولة، إلا أن هناك حاجة لمزيد من الربط بين المحتوى النظري والتطبيق العملي.
- أبدى الطلبة رضاهم عن تكامل المقررات الدراسية بنسبة جيدة (68%)، لكنهم أشاروا إلى ضعف في مستوى استيعاب بعض المقررات (64%) مما يستلزم مراجعة طرائق الشرح.
2- أساليب ووسائل التعليم (66% – 3.9)
- الوسائل التعليمية مثل العروض والمختبرات والمنصات الإلكترونية وُصفت بأنها “فعالة نسبيًا”، لكن هناك تفاوت في استخدامها بين الأقسام.
- التقييمات اعتُبرت عادلة وشفافة بنسبة (68%)، مع وجود مطالبات بمزيد من التنوع في أساليب القياس.
- التفاعل مع الطلبة والأنشطة الصفية حظي بتقييم جيد، لكنه يحتاج إلى تنشيط أكبر ليعزز المشاركة الطلابية.
3- التعليم الإلكتروني والتعلم المدمج (63% – 3.8)
- المنصات الإلكترونية (مثل Google Classroom, Moodle, LMS) وُصفت بأنها سهلة الاستخدام وفعّالة، بنسبة (66%).
- المحور الأضعف هنا هو الجمع بين التعليم الحضوري والإلكتروني (57%)، ما يشير إلى قصور في تطبيق التعلم المدمج.
- استخدام التقنيات الحديثة (الذكاء الاصطناعي، المحاكاة) حصل على تقييم جيد (66%)، مع مطالبات بتوسيع الاعتماد عليها.
4- تلبية احتياجات الطلبة (63% – 3.8)
- تلبية الاحتياجات الأكاديمية (مراجع، مكتبات، مختبرات) جاءت الأعلى (71% – 4.3)، ما يعكس اهتمام الجامعة بتطوير بنيتها العلمية.
- أما الاحتياجات التقنية (56%) فقد كانت الأضعف، ما يعكس حاجة إلى تعزيز البنية الرقمية والتقنيات التعليمية.
- الاحتياجات الإدارية (62%) والبيئية (61%) جاءت بتقييم متوسط، مما يبرز الحاجة إلى تحسين الخدمات الطلابية والبيئة الصفية.
رابعًا: التوصيات
- مراجعة تصميم المقررات الدراسية لضمان تحقيق التوازن بين الجانب النظري والتطبيقي.
- تنويع الوسائل التعليمية وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل المحاكاة والتجارب الافتراضية.
- تعزيز التعلم المدمج عبر خطط واضحة تجمع بين التعليم الحضوري والإلكتروني بكفاءة.
- تحسين البنية الرقمية وتطوير منصات إلكترونية أكثر تكاملًا لدعم الطلبة.
- رفع مستوى الخدمات الإدارية لتسهيل إجراءات التسجيل والدعم الطلابي.
- تحسين البيئة الجامعية من خلال تطوير المختبرات والقاعات وتوفير بيئة محفزة.
- تفعيل التغذية الراجعة المستمرة بين الطلبة والأساتذة لضمان تطوير المقررات بشكل مستمر.
خامسًا: الخاتمة
تُظهر نتائج استبيان تقييم جودة التعليم والتعلم في جامعة الحلة أن هناك مستوى متوسطًا من الرضا العام (65% ) مع تفاوت ملحوظ بين المحاور. ورغم وجود نقاط قوة في وضوح الأهداف التعليمية وتوافر المراجع الأكاديمية، إلا أن التحديات في مجال التعليم المدمج، والاحتياجات التقنية، والخدمات الإدارية تشكل عائقًا أمام تحقيق مستوى أعلى من الجودة.
يمثل هذا التقييم فرصة مهمة لإدارة الجامعة للعمل على تطوير سياسات التعليم والتعلم، وتعزيز الابتكار في العملية التعليمية، بما يضمن تلبية تطلعات الطلبة، وتحسين تصنيف الجامعة، وتعزيز مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة. إن الأخذ بهذه النتائج والتوصيات سيُسهم في تحقيق نقلة نوعية نحو تعليم جامعي أكثر فاعلية وشمولية واستدامة.
أولاً: المقدمة
في إطار سعي جامعة الحلة إلى تعزيز بيئة البحث العلمي وتطوير مخرجاته النوعية، تأتي أهمية تقييم فاعلية توفير المستلزمات البحثية كخطوة محورية لدعم الباحثين وطلبة الدراسات العليا، ورفع مستوى النشر العلمي وتوسيع المشاركة في المشاريع الوطنية والدولية. إن توفير مستلزمات البحث العلمي لا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يشمل كذلك الدعم المالي، وتحفيز النشر، وتوفير المصادر الحديثة، وضمان بيئة حاضنة للابتكار والاستقصاء العلمي.
انطلاقًا من هذا الفهم، نفذت الجامعة استبيانًا موجهًا لأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا، لقياس آرائهم حول مدى توفر وتكامل البيئة البحثية في الجامعة. ركّز الاستبيان على أربعة محاور رئيسة: البنية التحتية والتجهيزات، الدعم المالي والتشجيع على النشر، توفر المصادر الرقمية والورقية، ومدى إسهام الموارد البحثية في إنتاج بحوث رصينة.
ويأتي هذا التقرير التحليلي استجابةً لتلك المؤشرات، حيث يهدف إلى تشخيص واقع المستلزمات البحثية في الجامعة، وتحديد النقاط القوية والضعف، وتقديم توصيات عملية للارتقاء بمستوى الدعم البحثي بما يتناسب مع متطلبات التصنيفات العالمية ورؤية الجامعة في أن تكون مركزًا بحثيًا رائدًا في المنطقة.
ثانيًا: تحليل النتائج الكمية
| رقم المحور | المؤشر | النسبة | المتوسط الحسابي |
| 1 | الموارد المتاحة من بنى تحتية وتجهيزات مختبرية تلبي احتياجات البحث العلمي | 77% | 4.6 |
| 2 | تقديم الجامعة دعمًا ماليًا وجوائز لتشجيع النشر العلمي | 67% | 0.4 |
| 3 | توفر المصادر الورقية والإلكترونية وقواعد البيانات | 72 % | 4.3 |
| 4 | الموارد البحثية في الجامعة تلبي القدرة على إنتاج بحوث مبتكرة | 63 % | 3.8 |
| المعدل العام لكفاءة المرافق | %69 | 4.2 | |
ثالثًا: التحليل النوعي للمحاور
- البنية التحتية والتجهيزات البحثية (4.6 – 77%)
أظهر هذا المحور أعلى نسبة رضا، مما يشير إلى توفر جيد للمختبرات، والمعدات، والبنية التحتية الداعمة. ويعكس هذا الاستثمار المباشر من الجامعة في تعزيز بيئة البحث العلمي. ومع ذلك، فإن التفاوت بين الكليات وتخصصاتها المختلفة يفرض الحاجة إلى مراجعة تفصيلية لتوزيع الموارد .
- الدعم المالي والتشجيع على النشر (4.0 – 67%)
رغم وجود حوافز وجوائز، إلا أن النتائج تُظهر أن الدعم المادي لا يزال غير كافٍ لتحقيق الطموحات البحثية. ويقترح المشاركون بضرورة تخصيص صناديق تمويلية تنافسية، وتوسيع نطاق دعم المجلات العلمية المحكمة والمشاريع التعاونية.
- توفر المصادر الورقية والإلكترونية (4.3 – 72%)
يمثل هذا المحور أحد الأركان الحيوية للبحث، والنتائج تعكس مستوى جيد من الإتاحة. إلا أن العديد من الباحثين أشاروا إلى الحاجة لتحديث قواعد البيانات والاشتراكات الدورية، وربطها بالاحتياجات الفعلية للتخصصات.
- إسهام الموارد في إنتاج بحوث مبتكرة (3.8 – 63%)
هذا المحور كان الأضعف في التقييم، ويشير إلى فجوة حقيقية بين الموارد المتاحة والابتكار العلمي. يظهر أن الموارد وحدها غير كافية ما لم يتم تفعيل منظومة البحث من خلال فرق بحثية متعددة التخصصات، وبرامج إشرافية قوية، وورش تطوير مهارات بحثية.
رابعًا: التوصيات
- زيادة الاستثمارات في المختبرات المركزية وتوفير تجهيزات نوعية تدعم البحوث التطبيقية.
- توسيع برامج التمويل البحثي وإنشاء صناديق تنافسية للباحثين الشباب ومشاريع الدراسات العليا.
- الاشتراك الدائم والموسع في قواعد بيانات علمية عالمية مثل (Scopus، Springer، )
- ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع المحلي وسوق العمل لإنتاج بحوث ذات أثر تطبيقي.
- تعزيز ثقافة النشر العلمي من خلال ورش عمل، وحملات توعية، وبرامج تحفيز.
- تطوير بوابة إلكترونية موحدة لإدارة المشاريع البحثية ومتابعة تقدمها.
- إقامة شراكات بحثية مع جامعات عالمية ومراكز بحثية لتبادل المعرفة والمصادر.
- تأسيس لجنة إشرافية عليا للبحث العلمي تتابع المؤشرات وتقيّم الأداء سنويًا.
- دعم النشر في مجلات ذات معامل تأثير من خلال تغطية رسوم النشر أو تقديم منح خاصة.
- تقييم دوري لمدى كفاءة استخدام الموارد البحثية وتحسين آليات إدارتها داخل الكليات والمراكز.
خامسًا: الخاتمة
تعكس نتائج استبيان فاعلية توفير المستلزمات البحثية في جامعة الحلة وجود بنية أولية جيدة تستند إليها الجامعة في دعم البحث العلمي، ولكنها لا تزال بحاجة إلى إعادة تنظيم وتحفيز وتوجيه بشكل ممنهج ومنظم. ورغم توفر التجهيزات الأساسية، إلا أن فجوة الابتكار والإنتاج البحثي النوعي ما زالت قائمة، مما يتطلب سياسات أكثر طموحًا واستجابة لتحديات العصر.
إن بناء نظام بحثي قوي لا يتوقف عند وفرة الموارد، بل يتطلب بيئة فكرية محفزة، وثقافة مؤسسية تشجع المبادرة، وتكاملًا بين مكونات البحث من تمويل، وتدريب، ومصادر، وتقييم. تمثل التوصيات المذكورة أعلاه خارطة طريق لتحويل الجامعة إلى مركز بحثي مؤثر، ومنصة علمية قادرة على المنافسة على المستويين المحلي والدولي.
وتأمل الجامعة من خلال هذا التقرير أن تكون قد وضعت يدها على مكامن التطوير الممكنة، لتتخذ خطوات جريئة نحو إرساء منظومة بحثية متكاملة تدعم الرصانة، وتؤمن الاستدامة، وتحقق الريادة في مجتمع المعرفة.
.
أولاً: المقدمة
في ضوء حرص جامعة الحلة على الارتقاء بجودة الحياة الجامعية، وتحقيق بيئة تعليمية متكاملة ومحفزة، تُولي الجامعة اهتمامًا بالغًا بالخدمات الطلابية باعتبارها أحد المحاور الجوهرية في تعزيز رضا الطلبة، وتكريس شعورهم بالانتماء، وتوفير مقومات النجاح الأكاديمي والنفسي والاجتماعي.
ومن منطلق التزامها بمبادئ الجودة والتحسين المستمر، أجرت الجامعة استبانة شاملة لتقييم جودة الخدمات الطلابية خلال العام الدراسي 2023–2024، بهدف الوقوف على مستوى رضا الطلبة عن المرافق التعليمية، والخدمات الأكاديمية، والدعم الإرشادي، والتغذية، والصحة الجامعية، وغيرها من الجوانب الخدمية الأساسية.
تشكل نتائج هذا الاستبيان أداة علمية حيوية تساعد في تحليل الأداء الخدمي من منظور الطلبة أنفسهم، بما يعزز من موثوقية التقييم، ويُسهم في تطوير خطط التحسين والتحديث ضمن استراتيجية الجامعة الشاملة نحو التميز المؤسسي.
ثانيًا: تحليل النتائج الكمية
| رقم المحور | المؤشر | النسبة | المتوسط الحسابي |
| 1 | توفر الجامعة مرافق تعليمية (القاعات الدراسية والمختبرات والمكتبات) تلبي الاحتياجات الأساسية | 85% | 5.1 |
| 2 | تلبي الإرشادات الأكاديمية احتياجاتك الأكاديمية بشكل كافٍ | 79% | 4.8 |
| 3 | وجود نادي طلابي ومحلات تقدم خدمات متنوعة | 77% | 4.6 |
| 4 | توفر أطعمة متنوعة وذو جودة عالية في النادي الطلابي والمطاعم الأخرى | 69% | 4.1 |
| 5 | تتوفر خدمات صحية أولية في الجامعة | 76% | 4.6 |
| المعدل العام | 77% | 4.6 | |
ثالثًا: التحليل النوعي للمحاور
- توفر مرافق تعليمية ملائمة (85% – متوسط 5.1)
أعلى تقييم في الاستبيان، ويعكس مستوى عالٍ من الرضا عن البنية التحتية التعليمية الأساسية في الجامعة. هذه النتيجة تشير إلى استثمار واضح في القاعات الدراسية، المختبرات، والمكتبات، ما يُعزز من جودة العملية التعليمية ويدعم البيئة الأكاديمية.
- فعالية الإرشاد الأكاديمي (79% – متوسط 4.8)
تشير النتائج إلى رضا جيد عن خدمات الإرشاد الأكاديمي، مما يدل على وجود تواصل إيجابي بين الطلبة والمرشدين الأكاديميين. ومع ذلك، فالمجال لا يزال مفتوحًا لتعزيز التفاعل المستمر، وتخصيص وقت كافٍ للإرشاد الفردي، وتوفير تدريب متجدد للمرشدين.
- تنوع الأنشطة والخدمات الطلابية (77% – متوسط 4.6)
تعكس هذه النتيجة وجود اهتمام بالخدمات الترفيهية والأنشطة غير الصفّية. ولكنها تستوجب المزيد من التنوع والشمول للفئات الطلابية المختلفة، وتوسيع نطاق الأندية، والأنشطة الثقافية، والخدمات المتخصصة.
- جودة التغذية والخدمات الغذائية (69% – متوسط 4.1)
هذا المحور سجل أقل نسبة رضا، مما يشير إلى تحديات حقيقية في نوعية أو تنوع الأطعمة المقدمة في النادي الطلابي والمطاعم. وتُعد هذه الفقرة مؤشرًا على أهمية مراجعة عقود التغذية، وضمان جودة صحية وتغذوية مناسبة.
توفر الخدمات الصحية (76% – متوسط 4.6)
تدل النتيجة على مستوى مقبول من الرضا، لكنه لا يرقى إلى مستوى التميز. ويستدعي الأمر تحسين البنية الصحية الجامعية من خلال تطوير وحدات الإسعافات الأولية، وتوفير أطباء متخصصين، وتقديم حملات توعية صحية دورية.
رابعًا: التوصيات
- استمرار تطوير البنية التحتية التعليمية من قاعات ومختبرات ومكتبات رقمية ومرافق ذكية.
- تحسين نظام الإرشاد الأكاديمي من خلال رقمنة الخدمات وتخصيص مرشدين دائمين بكل كلية.
- تنويع الخدمات الطلابية وتوسيع أندية الطلبة لتشمل الرياضة، الفنون، والتكنولوجيا.
- إعادة النظر في الخدمات الغذائية من حيث التنوع، الجودة، والنظافة، وعقد شراكات مع مزودي خدمة متخصصين.
- تحديث مراكز الرعاية الصحية الجامعية وفتح عيادات تخصصية بالتعاون مع كلية الطب أو المستشفيات المجاورة.
- تفعيل استبيانات دورية لقياس رضا الطلبة حول كل خدمة بشكل منفصل.
- إنشاء وحدة مركزية لجودة الحياة الطلابية تشرف على جميع الجوانب المرتبطة بالخدمات الجامعية.
- ربط جودة الخدمات الطلابية بنظام الحوافز والتقييم الإداري لضمان استدامة التحسين.
- تقديم تدريب وتوعية للطلبة حول الاستفادة من الخدمات المتاحة.
- التحول نحو نموذج الجامعة الصديقة للطالب عبر برامج داعمة للصحة النفسية والاجتماعية.
خامسًا: الخاتمة
تشير نتائج استبيان جودة الخدمات الطلابية إلى وجود مستوى عام جيد من الرضا بين الطلبة، خاصة في ما يتعلق بالبنية التعليمية والإرشاد الأكاديمي. ومع ذلك، فإن بعض المحاور الحيوية مثل التغذية والرعاية الصحية تحتاج إلى تدخلات فاعلة وخطط تحسين مستعجلة لضمان تحقيق التكامل في البيئة الجامعية الداعمة.
إن تطبيق التوصيات المستخلصة من هذا التقييم سيُسهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة الجامعية وتعزيز انتماء الطلبة ورضاهم، مما ينعكس إيجابيًا على مخرجات التعليم، ويعزز من موقع الجامعة في التصنيفات الأكاديمية الوطنية والإقليمية، ويضعها في مصاف الجامعات التي تكرّس ثقافة الرعاية الشاملة والتميز الخدمي.